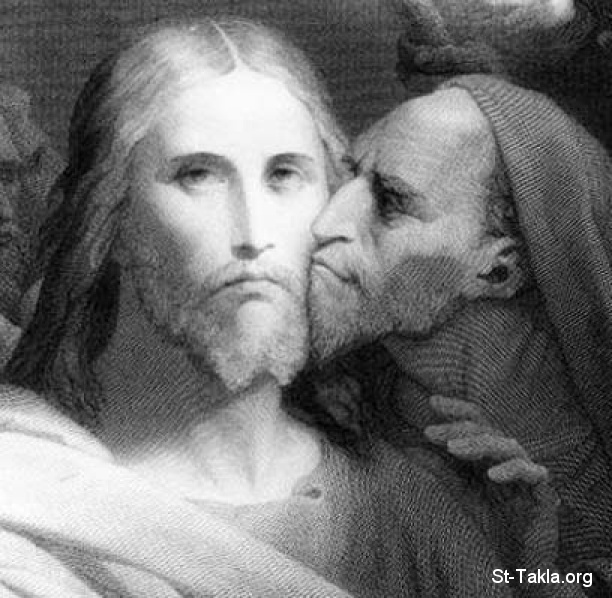الرب يسوع رسالة السماء للأجيال كافة
«يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد» (عب 13: 8)
«يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد» (عب 13: 8)
عشرون قرناً مضت وانقضت
على ميلاد ربنا يسوع المسيح بالجسد، من الروح القدس والسيدة العذراء مريم.
ولم يكن ميلاده ذاك بدء تاريخه، فهو كلمة اللّـه الذي ولد من الآب قبل كل
الدهور، وهو مساوٍ للآب في الجوهر. ويلخّص الرسول يوحنا حقيقة ميلاده
الأزلي كما يوضّح عقيدة ميلاده الزمني وهو يستهل الإنجيل المقدس بقوله:
«في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند اللّـه وكان الكلمة اللّه، هذا كان
في البدء عند اللّه كل شيء به كان و بغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت
الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه…
والكلمة صار جسداً وحلّ فينا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً
نعمةً وحقاً»(يو1: 1 ـ 5 و14). ويصف الرسول بولس عقيدة تجسد كلمة اللّـه
بقوله: «وبالإجماع عظيم هو سر التقوى اللّـه ظهر في الجسد تبرّر في الروح
تراءى لملائكة كُرز به بين الأمم أومن به في العالم رُفع في المجد»(1تي3:
16). ويوضّح الرب يسوع الغاية السامية من مجيئه إلى عالمنا بقوله: «لأنه
هكذا أحب اللّـه العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل
تكون له الحياة الأبدية»(يو3: 16).
أجل!
نزل ابن اللّـه الوحيد من السماء إلى أرضنا هذه وصار إنساناً، لا ليُضاف
اسمه القدوس إلى أسماء الرسل والأنبياء بل ليكون هو ذاته رسالة السماء
لبني البشر في أجيالهم كافة. فهو «هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد» على حدّ
تعبير الرسول بولس، فيه تمّت نبوات الأنبياء القدامى بحذافيرها، وهو
مشتهى الأجيال، وهو الكاهن إلى الأبد على رتبة ملكيصادق الذي قدّم ذاته
بإرادته ذبيحة كفارية عن البشرية، فبررنا نحن المؤمنين به وقدّسنا وجعلنا
أبناء للّه بالنعمة المولودين ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة
رجل بل من اللّـه (يو1: 13) فقد وُلد ابن اللّـه الوحيد بالجسد على الأرض.
لنولد نحن بالروح من السماء، ودُعي ابن البشر لنصير نحن المؤمنين به
أولاداً للّه بالنعمة. وأسس كنيسته المقدسة على صخرة الإيمان به أنه ابن
اللّـه الحي (مت16: 16) وجعل منها مخزن نعمه الإلهية، وأقام فيها وكلاء
سرائره الرسل والتلاميذ الأبرار الأحبار والكهنة ليوزّعوا هذه المواهب
السماوية والعطايا الصالحة على المؤمنين به.
ومرّت
الدهور إثر الدهور وكرّت الأجيال عقب الأجيال، وكنيسة الرب يسوع تنير
بنوره الجالسين في الظلمة وظلال الموت وتوزّع النعم الإلهية على مستحقيها،
وها نحن بنعمة اللّـه على مشارف القرن الحادي والعشرين نقدم الشكر للّه
الذي أبقانا إلى اليوم أحياء، وأنعم علينا بأن نكون في عداد أعضاء كنيسته
المقدسة التي أحبها وأسلم نفسه لأجلها وافتداها بدمه الكريم، «لكي يقدّسها
مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس
فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب»(أف5: 26و27) وجعل
رايتها صليبه المقدس، الذي علق عليه ومات وفدانا من الموت والشيطان
والخطية. كما أعطاها إنجيله المقدس الموحى به من اللّـه دستوراً أبدياً
وضمّنه تعاليمه الإلهية وشهادة تلاميذه الذين كانوا معه مرافقين إياه منذ
بدء تدبيره الإلهي بالجسد. والإنجيل المقدس هو الذي كشف النقاب عن حقيقة
هوية الرب يسوع، وبهذا الصدد يوضّح الرسول يوحنا الغاية من كتابته الإنجيل
المقدس بقوله: «وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن اللّـه
ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه»(يو20: 31).
وأنار
الإنجيل المقدس دياجير الظلام الذي كان مخيّماً على عقول البشر وقلوبهم.
وكشف النقاب عما تسرّب إلى الديانة اليهودية من ضلالات الديانة الوثنية
الخبيثة والتعاليم الباطلة البعيدة عن روح شريعة موسى الأدبية. وفي خطبته
على الجبل صحّح الرب يسوع المفاهيم الدينية الروحية والأخلاقية لدى البشر
ونادى بمحبة اللّـه والقريب وحتى محبة الأعداء، وأرسى القاعدة الذهبية
بمعاملة الإنسان لأخيه الإنسان قائلاً: «فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم
افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء»(مت7: 12) ودعا
المتعبين إلى الاقتداء به قائلاً: «تعالوا إليّ يا جميع المتعبين والثقيلي
الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلّموا مني لأني وديع ومتواضع
القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هيّن وحملي خفيف»(مت11: 28 ـ 30).
وأقام
الرب يسوع من نفسه القدوة الصالحة للإنسان الذي كان قد ملّ النواميس،
والنظم، والطقوس التي لم تعد تروي نفسه العطشى إلى البر، وأصبح ينشد ويبحث
عن مثال ينسج على منواله، ويطبع على غراره ويشبع جوعه وعطشه إلى البر،
حتى وجد ذلك بالرب يسوع الذي لفت أنظار الناس إليه لا إلى غيره. ونادى
أمام الغريب والقريب، العدو والصديق قائلاً: «من يبكّتني على خطية»(يو8:
46) فلزموا جانب الصمت ولم ينبس أحد منهم ببنت شفة، ذلك أن حياة الرب يسوع
كانت أنقى من ثلوج الجبال، لا يشوب سيرته الطاهرة وسريرته المقدسة شائبة
ولم يوجد في فمه غش.
وعندما
سئل مرة عن الطريق المؤدية إلى السماء أجاب: «أنا هو الطريق والحق
والحياة»(يو14: 6) كما أجاب الشاب الذي سأله عما يفعل ليرث الحياة الأبدية
قائلاً: «إن أردت أن تكون كاملاً فاذهب وبع أملاكك وأعطِ الفقراء فيكون
لك كنز في السماء وتعال اتبعني»(مت19: 17 ـ 21). فهو رسالة السماء للأجيال
كافة.
وقد أعلن الرب
يسوع أمام الملأ أنه مساوٍٍ للّه الآب في الجوهر، وأنه هو والآب واحد،
وسمعناه يجيب تلميذه فيلبس قائلاً: «الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول
أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيّ؟»(يو14: 9و10). كما
بيّن أن مجيئه إلى العالم هو لخلاص العالم وأنه «يُسلّم إلى أيدي الناس
فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم»(مت17: 22و23) وهكذا كان. وقد برهنت
قيامته من بين الأموات على قبول الآب ذبيحته الكفارية التي قدّمها بإرادته
عن البشرية، وبهذا الصدد جاء على لسانه في سفر الرؤيا قوله: «أنا هو
الأول والآخر والحي وكنت ميتاً و ها أنا حيّ إلى أبد الآبدين آمين، ولي
مفاتيح الهاوية والموت»(رؤ1: 17و18) فربنا وفادينا يسوع المسيح حيّ وهو:
«هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد»(عب13: 8) وإن آية قيامته من بين الأموات
تبرهن على صدق وعده بإقامة الموتى في اليوم الأخير، الوعد الذي أعلنه
بقوله: «لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون
له حياة في ذاته وأعطاه سلطاناً أن يدين أيضاً لأنه ابن الإنسان لا
تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج
الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة
الدينونة»(يو5: 26 ـ 29). فالمسيح يسوع حي، ويُحيي الموتى، وقد دُعي اسمه
يسوع لأنه يخلّص شعبه من خطاياهم (مت1: 21) كما دُعي اسمه المسيح أي
الممسوح الذي مسحه اللّـه الآب وأرسله إلى العالم وهو المسيح الذي انتظره
شعب النظام القديم والشعوب كافة، وقد أعلن الرب يسوع هذا الاسم عندما دفع
إليه سفر اشعياء النبي في مجمع الناصرة ولما فتح السفر وجد الموضع الذي
كان مكتوباً فيه: «روح الرب عليّ لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي
المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل
المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه الى
الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه فابتدأ يقول
لهم إنه اليوم قد تمّ هذا المكتوب في مسامعكم»(لو4: 18 ـ 21 وأش61: 1) وقد
دعي اسمه عمانوئيل الذي تفسيره اللّـه معنا (مت1: 23). ووعدنا أن يكون
بيننا ومعنا دائماً قائلاً: «لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك
أكون في وسطهم»(مت18: 20) وبرهن على صدق وعده هذا له المجد عندما رافق
تلميذي عمواس اللذين كانا بطريقهما إلى قريتهما يوم قيامته من بين
الأموات، وعندما ظهر لتلاميذه في العلية مساء ذلك اليوم بالذات وكانت
أبواب العلية مغلقة. فهو حي وكنيسته تحيا فيه وهو رأسها وهي جسده السري،
وسيبقى معها إلى الأبد.
كم
عانت الكنيسة اضطهادات عنيفة وكابدت الآلام الفظيعة وقدمت الشهداء الذين
لا يحصى لهم عدد، خلال القرون العشرين منذ بدء وجودها وإلى الآن، ولكن
المسيح في وسطها فلن تتزعزع وقد وعدها أن «أبواب الجحيم لن تقوى
عليها»(مت16: 18) حتى أن دم الشهداء، كما قال آباؤنا القديسون صار بذار
الإيمان. وظهرت الهرطقات الخبيثة عبر الأجيال وحاولت تشويه الإيمان
المسيحي ولكن الروح القدس المنبثق من الآب، الذي حلّ على رسل الرب
والمؤمنين به في العلية على شبه ألسنة نارية، صان الكنيسة من الخطل والزلل
لأنه حسب وعد الرب يسوع هو مرشد الكنيسة وقائدها وحامي إيمانها. لذلك
دحضت الكنيسة عبر الأجيال الهرطقات الوخيمة والبدع الخبيثة وكانت الكنيسة
ولا تزال أمينة على الحفاظ على جوهرة الإيمان الذي تسلّمته من الرسل
الأطهار، الإيمان المعلن في الإنجيل المقدس والمؤيد بتعاليم الآباء
الرسوليين «الإيمان المسلَّم مرة للقديسين»(يه1: 3) لينال آباؤها المكافأة
من الرب عن ذلك. وبهذا الصدد يقول الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس: «اكرز
بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبّخ، انتهر، عِظ بكل أناة
وتعليم لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم
الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحِكَّةً مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق و
ينحرفون إلى الخرافات … قد جاهدتُ الجهاد الحسن، أكملتُ السعي حفظتُ
الإيمان وأخيراً قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب
الديّان العادل وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً»(2تي4: 1 ـ
8).
أجل خلال القرون
العشرين منذ بدء المسيحية وإلى اليوم جاهدت الكنيسة الجهاد الحسن وحفظت
الإيمان ودحضت البدع الوخيمة ودحرتها في مجامعها المسكونية والمكانية
وحرمتها ومبتدعيها والهراطقة كافة وحددت دساتير الإيمان منذ عهد الرسل
التي لخّصها المجمع النيقاوي عام 325 بدستور الإيمان النيقاوي الذي تتلوه
الكنيسة في قداديسها وصلواتها اليومية. ولكن إبليس اللعين لا يزال يخدع
بعض البشر فيتبعونه ويخضعون لأوامره ويتحوّلون إلى ضالين ومضلّين. وبهذا
الصدد يقول الرب يسوع عن الأيام الأخيرة: «لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء
كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضاً. ها أنا
قد سبقت وأخبرتكم»(مت24: 24و25) ويقول الرسول بولس: «ولكن الروح يقول
صريحاً أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحاً مضلّة
وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم»(1تي4: 1و2) وكأني
بالرسول بولس يرى معنا بعض المؤسسات التي تدّعي بالمسيحية في هذه الأيام
والمسيحية براء منها لأنها قد حادت عن جادة الحق وخضعت لإبليس اللعين،
وتبنّت البدع الحديثة والقديمة، كما انحطت إلى درك الرذائل. والرسول بولس
يأمرنا بأن نعزل الخبيث من بيننا، ونعرض عن هؤلاء المحبين للذات دون محبة
اللّـه ولهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها (2تي3: 1 ـ 5).
أيها
الأحباء: إنها السنة الأخيرة من القرن العشرين، وإننا على وشك أن نضع
أقدامنا على أول عتبة من عتبات القرن الحادي والعشرين، والمستقبل مجهول
لدينا، وإن قاربنا صغير ونحن نمخر عباب اليم الخِضَمّ الذي لا قرارة له،
والعواصف العاتية والأمواج المرتفعة تصدم قاربنا الصغير وتكاد تبتلعه. وقد
شابهنا بقلة إيماننا التلاميذ الذين كانوا في السفينة مع الرب يسوع «وإذا
اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطّت الأمواج السفينة وكان هو نائماً
فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين يا سيد نجنا فإننا نهلك فقال لهم ما بالكم
خائفين يا قليلي الإيمان ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء
عظيم»(مت8: 23 ـ 26) لقد بدت قلة إيمان التلاميذ بخوفهم الشديد وهم
يتوقّعون غرق السفينة وغاب عن بالهم أنه طالما المسيح في السفينة فلن تغرق
أبداً مهما كانت العواصف شديدة وكان البحر هائجاً. وإن الرب يسوع المسيح
هو رأس الكنيسة وهي جسده السرّي وهو معها وقد وعدها أنّ أبواب الجحيم لن
تقوى عليها فما علينا إلاّ أن نستقبل القرن القادم بإيمان ورجاء ومحبة وأن
نؤمن بأن المسيح معنا وإذا كنا قد ابتعدنا عنه كابتعاد الابن الضال عن
أبيه في أرض غريبة وتمرغه بالآثام، علينا أن نقتدي به بتأملنا بالسعادة
الروحية التي شملتنا يوم كنا في بيت الآب نتمتع بامتيازات البنوة الحقيقية
ونتأمل بحالتنا التعيسة ونحن بعيدون عنه، لنرى أن آثامنا قد صارت حقاً
فاصلة بيننا وبين إلهنا، وعلينا كالابن الشاطر أن نقوم حالاً ونبدأ رحلة
العودة إلى بيت أبينا السماوي ونقول له: يا أبانا الذي في السموات لقد
أخطأنا إليك ولا نستحق أن ندعى لك بنين فاقبلنا كعبيدك. وسنرى أن أبانا لا
يزال بانتظارنا وأنه سيجدد العهد معنا بإعادته إلينا خاتم العهد ويولم
لنا فرحاً، بل أيضاً تبتهج ملائكة السماء بعودتنا إليه لأنها تفرح بخاطئ
واحد يتوب وبذلك نعود إلى رتبة البنين ونستحق أن نرث ملكوته السماوي.
لنستعد
إذن أيها الأحباء لنبدأ مشوارنا في القرن الحادي والعشرين بإيمان متين
ورجاء وطيد ومحبة للّه والقريب وبتوبة صادقة نصوح واثقين أن الرب يسوع هو
معنا وأن الروح القدس هو مرشدنا ومعلمنا ومقدسنا. ولنشكرن اللّـه تعالى
الذي أبقانا أحياء حتى الآن، ولننتظر مجيئه الثاني الذي لا نعلم متى يكون
ولكننا علينا أن نكون ساهرين ولا ننخدع بالمضلين الذين مرات عديدة عبر
القرون العشرين، حدّدوا مواعيد مجيئه الثاني وكانوا كاذبين، لأن الرب
نبّهنا بقوله: «أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة
السموات إلا أبي»(مت24: 36)، «اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون في أية ساعة
يأتي ربكم»(مت24: 42). قال الرسول يوحنا في سفر الرؤيا: «هوذا يأتي مع
السحاب وستنظره كل عين»(رؤ1: 7) ويختم رؤياه بقوله على لسان الرب: «أنا
آتي سريعاً» ويوحنا يجيب الرب بشوق وإيمان: «آمين تعال أيها الرب
يسوع»(رؤ22: 20). إن الرب يسوع لا بد أن يأتي ثانية حسب وعده، ولئن نظن
أنه قد أبطأ مجيئه ولكن علينا ونحن نقف على أصابع أقدام الانتظار ناظرين
إلى السماء منتظرين مجيئه أن نعيش كما يحق لإنجيل المسيح (في1: 27) مؤمنين
أن مسيحيتنا يجب أن تكون منسجمة مع سيرة الرب يسوع المسيح الذي هو رسالة
السماء لنا نحن الساكنين في الأرض. فلا بد أن تظهر مسيحيتنا على حقيقتها
نقية طاهرة أمام الناس كافة، لأننا سفراء الرب يسوع على الأرض، والرب يسوع
الذي يحيطنا بعنايته، ويرمقنا بعين رعايته، يعتبر كل ما يصيبنا من ضيقات
أو اضطهادات يصيبه هو بالذات، فقد ظهر لشاول الطرسوسي يوم كان شاول في
طريقه إلى دمشق ليضطهد أتباع الرب يسوع هناك وقال له: «شاول شاول لماذا
تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب
عليك أن ترفس مناخس»(أع9: 4و5). لم يضطهد شاول الرب يسوع ولكنه اضطهد
المؤمنين به ومن هنا نعلم أن المسيحية هي المسيح بالذات، وقد وعد الرب
يسوع رسله بقوله: «الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم يرذلني، والذي
يرذلني يرذل الذي أرسلني»(لو10: 16) فالذي يضطهد أتباع المسيح يضطهد
المسيح. فما أعظم محبة الرب للمؤمنين به وما أجسم مسؤوليتنا تجاه هذه
المحبة التي يجب أن تقابل بمثلها، فواجبنا نحن المؤمنين به أن نكون أنقياء
أتقياء مرضيين لديه له المجد، لنستحق أن نكون شهوداً صادقين له في هذه
الحياة الدنيا، متحمّلين المشقات كجنود صالحين (2تي2: 3) متألّمين معه، حتى
نكون في مجيئه الثاني في عداد الذين يتمجدون معه (رو1: 11) وارثين ملكوته
السماوي.
علينا أن نستيقظ من نوم الخطية ونصحو ونسهر ونحن نحث الخطى نحو القرن الحادي والعشرين بإيمان متين ورجاء وطيد.
أيها
الأحباء: إنها أيضاً لفرصة ذهبية سانحة لنا جميعاً ونحن نستقبل الصوم
الأربعيني المقدس أن نتوب توبة حقيقية وأن نقرن الصوم بالصلاة وتوزيع
الصدقات طالبين إلى اللّـه أن يتقبل صومكم وصلواتكم وصدقاتكم وأن يؤهّلكم
لتحتفلوا بعيد قيامته من بين الأموات وأنتم متسربلون بثوب البر والتقوى
ومخافة اللّه بنعمته تعالى آمين